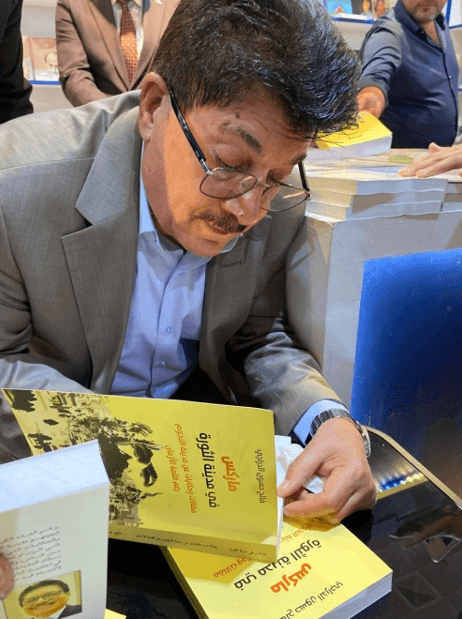د كمال هاشم
في لحظةٍ فارقة من عمره، توقّفت مسيرة محمد مصطفى أبو الحسن الدراسية التي أظهر فيها نبوغا لفت إليه الأنظار منذ يومه الجامعي الأول. لم يكن ذلك نتيجة إخفاق أو اختيار، بل لأن الحرب باغتت حلمه، كما باغتت آلاف السودانيين. كان طالبًا بكلية الفنون الجميلة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، يسير بثقة نحو بناء مشروعه الفني، قبل أن يجد نفسه، ككثير من المبدعين الشباب، في مواجهة فقدٍ قاسٍ: فقدُ المرسم، وفقدُ الأعمال، وفقدُ المسار الأكاديمي. لكن ما لم يفقده محمد قط هو إيمانه العميق بأن الفنّ يمكن أن يكون حياةً بديلة، أو مقاومة صامتة، أو حتى عزاءً لا يذبل.
من هذا المنعطف المؤلم، تولدت تجربة فنية مختلفة، يمكن القول إنها انبثقت من الهامش، لكنها سرعان ما فرضت حضورها بصوتٍ بصريّ خاص، مشحون بالعاطفة، ومشحون بالمعنى. يعيش محمد اليوم في ولاية كسلا، مستعيدًا أدواته من الصفر تقريبًا، لكن بأسلوبٍ فنيّ أكثر نضجًا وصدقًا.
ما يلفت النظر في أعماله المرفقة بهذه المقالة هو استخدامه المستمر لخامة القماش، تحديدًا بقايا “التوب” السوداني، ذلك الزيّ النسائي التقليدي الذي يحمل في طيّاته لا فقط زخارف وألوانًا، بل تاريخًا شخصيًا وجمعيًا، وروائح بيوت، وهمسات نساء، وصوت أمّ تخيط بثوبها الحكايات. يلتقط محمد هذه الأنسجة المهملة من البيوت والأسواق، ويعيد إليها الحياة، فيحوّلها إلى لغة تشكيلية ذات طابع وجداني وشعبي، ويمنحها مساحات التعبير، بعد أن كانت مجرد بقايا منسية.
في لوحاته، لا يكون “التوب” مجرد خامة تقنية، بل يصبح حاملًا لذاكرة النساء، ولبصمة الجدة، ولظلّ الأم. وهو بهذا يقدّم بعدًا أنثويًا في أعماله، دون أن يقع في المباشرة أو الاستدرار العاطفي، بل عبر نسيج بصري متقن، يجمع بين الرسم والكولاج والتصوير، ويعبر عن القهر والحنين والهوية السودانية الجريحة.
ما بين الأقمشة البالية والوجوه الشعبية، ما بين الألوان الصاخبة والفراغات الحزينة، يتنقل محمد في عمله كمن يسير في خرائط شخصية داخل وطنٍ منكسر. في بعض اللوحات، نرى احتفالات شعبية تُروى بالألوان، بينما في أخرى يهيمن صمت العربة المارة في أرضٍ صفراء على مشهدٍ رمزيّ يوحي بالترحال، أو بالنزوح القسري.
ورغم انقطاعه القسري عن التعليم الرسمي، فإن تجربة محمد تُثبت أن التعلّم لا يتوقف على الفصول الدراسية. لقد حوّل النقص إلى إمكان، والخسارة إلى طاقة خلق. لا يزال يرسم، ويقيم الورش الفنية للأطفال النازحين، ويعيد تكوين فنه من فتات الأشياء، ليصنع منها سردية نادرة لفنانٍ شابّ يرى الجمال في أكثر الأماكن هشاشةً.
يقول محمد إن الفنان الحقيقي هو من يصنع الأمل من رماد الألم، ويبدو أن كل لوحة من لوحاته هي ترجمة بصرية لهذا القول. فكل “توب” ممزق يلتحم على سطح لوحته مع لونٍ طازج ليشكل قصيدة مقاومة.
محمد مصطفى، الطالب الذي أوقفته الحرب، لم تتوقف روحه الفنية. بل أخذت شكلًا آخر: أكثر صدقًا، أكثر شاعرية، وأكثر حاجةً لأن تُسمع.