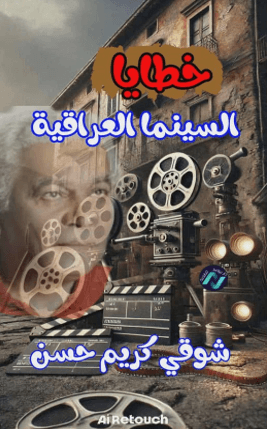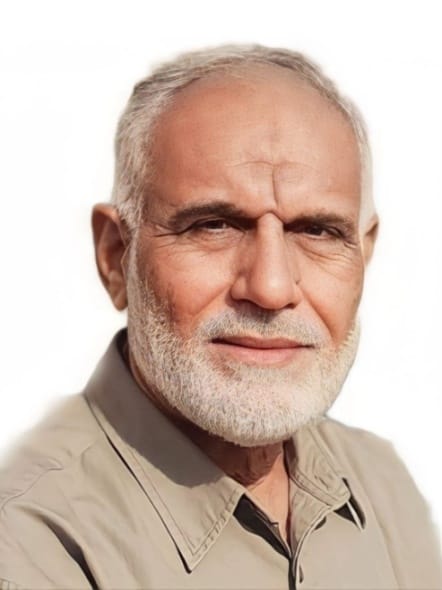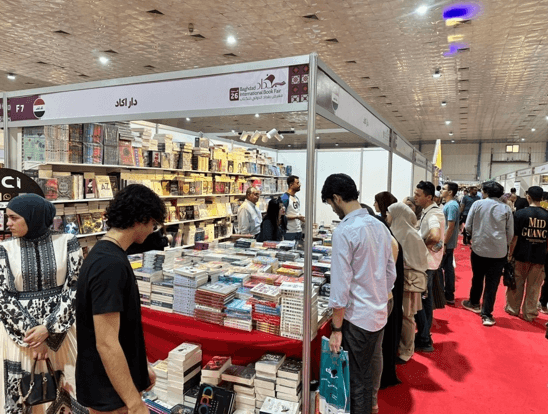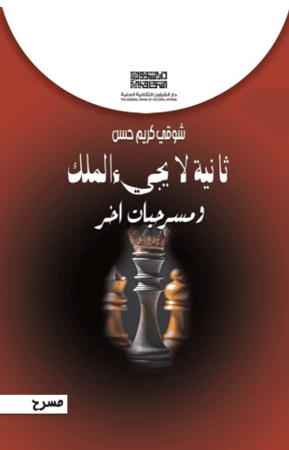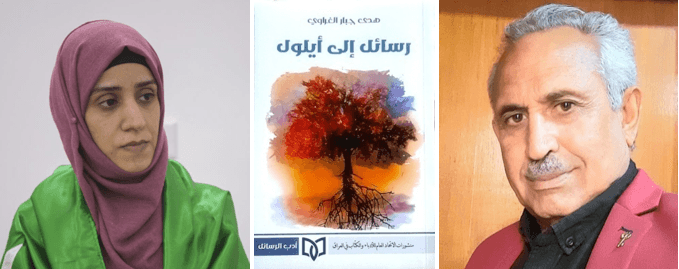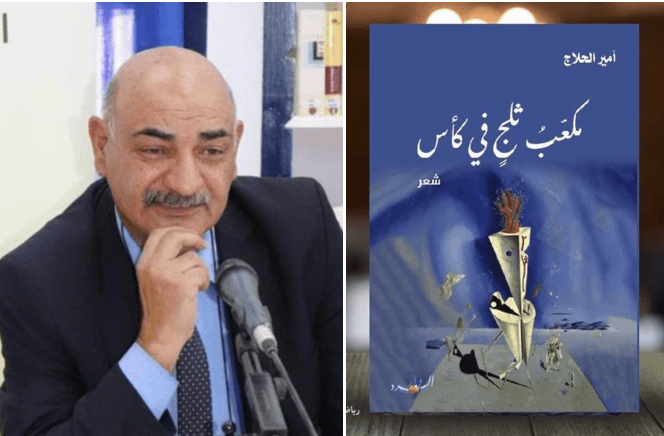(خطايا السينما العراقية)
لم تك السينما العراقية، منذ نشأتها في منتصف القرن العشرين، مجرّد مشروع فني يسعى إلى التعبير عن الذات الجمعية للمجتمع العراقي، بل كانت انعكاسًا دقيقًا لصراعاته السياسية والثقافية والاجتماعية. فهي لم تنشأ في بيئة طبيعية تتوافر فيها شروط الإبداع والاستمرارية، بل وُلدت وسط تناقضات حادّة جعلتها تتأرجح باستمرار بين الرغبة في تأسيس هوية سينمائية وطنية وبين الارتهان لإكراهات السلطة والظروف. ومن هذه التناقضات تفرعت «خطاياها» الكبرى، التي تراكمت عبر العقود حتى كوّنت صورة مشوّهة لهذا الفن في الذاكرة العراقية والعربية.منذ البدايات، وُضعت السينما العراقية في حضن المؤسسة الرسمية التي تعاملت معها باعتبارها وسيلة دعائية أكثر من كونها مشروعًا ثقافيًا. كانت الأفلام التي تُنتج في الخمسينيات والستينيات مرتبطة غالبًا بوزارات الإعلام أو الثقافة، ما جعلها خاضعة لرقابة صارمة وأجندات سياسية محددة.
لم تنظر الدولة إلى السينما باعتبارها فنًا حرًا قادراً على مساءلة الواقع أو نقده، بل أداة ترويج لخطابها، سواء كان قوميًّا أو اشتراكيًّا أو وطنيًّا. وهكذا، خُنقت المبادرات الفردية في مهدها، وتحوّلت الكاميرا إلى بوقٍ رسمي يكرّس الرواية السلطوية.لم تعرف السينما العراقية – بخلاف مثيلاتها في مصر أو إيران أو حتى سوريا – مفهوم “الصناعة” بالمعنى الاقتصادي والتجاري. فقد ظل الإنتاج السينمائي محدودًا، متقطعًا، وعشوائيًا، يخضع لظروف التمويل الحكومي أو لمبادرات شخصية غير مستمرة.
غياب شركات إنتاج حقيقية، وافتقار السوق لآليات توزيع وعرض راسخة، أدّى إلى حرمان السينما من أهم مقوّمات التطور: التراكم. فكل فيلم يُنتج كان أشبه بمحاولة يتيمة لا تجد من يتبعها، ما جعل تاريخ السينما العراقية سلسلة من البدايات غير المكتملة.من أبرز خطايا السينما العراقية ميلها الدائم إلى تقليد النماذج الأجنبية أو العربية دون سعي جاد لبناء لغة بصرية محلية. كثير من الأفلام عانت من ضعف في البناء الدرامي، سذاجة في الإخراج، وتكلّف في الأداء، نتيجة غياب مدارس حقيقية لتأهيل المخرجين والكتّاب والممثلين.
كما أن التجريب الفني ظل محدودًا للغاية، إذ جرى تجنّب الأساليب الجريئة أو غير المألوفة خوفًا من الرقابة أو من عدم القبول الجماهيري، ما جعل المشهد السينمائي جامدًا، مكرورًا، وغير قادر على إنتاج خطاب جمالي جديد. رغم أن السينما في جوهرها فنّ يعكس المجتمع ويخاطبه، إلا أن السينما العراقية كثيرًا ما ابتعدت عن نبض الواقع الشعبي، إمّا بدفعٍ من الرقابة السياسية أو نتيجة لنظرة نخبوية جعلتها تدور في فلك موضوعات بعيدة عن هموم الناس.
هذا الانفصال عن الواقع الاجتماعي أفقدها أهم وظائفها: القدرة على التأثير، وأدخلها في دائرة ضيّقة من الاهتمام النخبوي، تاركًا الجمهور في أحضان السينما التجارية الأجنبية أو العربية التي لبّت حاجاته الترفيهية والعاطفية.لا يمكن قراءة إخفاقات السينما العراقية بمعزل عن غياب النقد السينمائي الحقيقي. فقد ساد، لعقود طويلة، خطاب نقدي احتفائي أو مجامل، يتعامل مع كل إنتاج باعتباره «إنجازًا وطنيًا» بغض النظر عن مستواه الفني.هذا التواطؤ النقدي ساهم في ترسيخ الرداءة، لأن غياب النقد الجاد يعني غياب المساءلة، وغياب المساءلة يعني استمرار الأخطاء نفسها من دون تصحيح أو تطوّر.من أخطر ما واجه السينما العراقية هو انقطاع التراكم المعرفي والفني بين الأجيال. فالحروب والحصار والاضطرابات السياسية جعلت كل جيل يبدأ من الصفر، في غياب أرشيف منظم أو مدارس حقيقية أو مؤسسات تحفظ التجربة وتنقلها.
النتيجة كانت مشهدًا هشًّا، لا ذاكرة له ولا جذور متينة، وهو ما جعل كل محاولة جديدة أشبه بصرخة في الفراغ.ليست هذه الخطايا حُكمًا نهائيًا على السينما العراقية بقدر ما هي تشخيص لأسباب تعثّرها وفشلها في أن تصبح قوة ثقافية مؤثرة كما هي حال السينما في دول أخرى. غير أن الاعتراف بهذه الأخطاء هو الخطوة الأولى في طريق التصحيح.فلا مستقبل للسينما العراقية ما لم تتحرر من وصاية الدولة، وتبني صناعة حقيقية، وتؤسس لخطاب بصري أصيل يعكس واقع المجتمع العراقي وتحوّلاته. كما أن النقد الصادق، والتعليم المهني، وحماية الذاكرة السينمائية هي ركائز لا غنى عنها إذا ما أردنا لهذا الفن أن ينهض من عثراته، ويحتل مكانه الطبيعي في الثقافة العراقية والعربية. خطايا السينما العراقية» إذًا ليست مجرد لائحة اتهام، بل دعوة إلى المكاشفة والمراجعة، وإلى إعادة كتابة تاريخ هذا الفن بما يليق بإرث العراق الثقافي الغني، وبطموحاته التي لم تتحقق بعد.