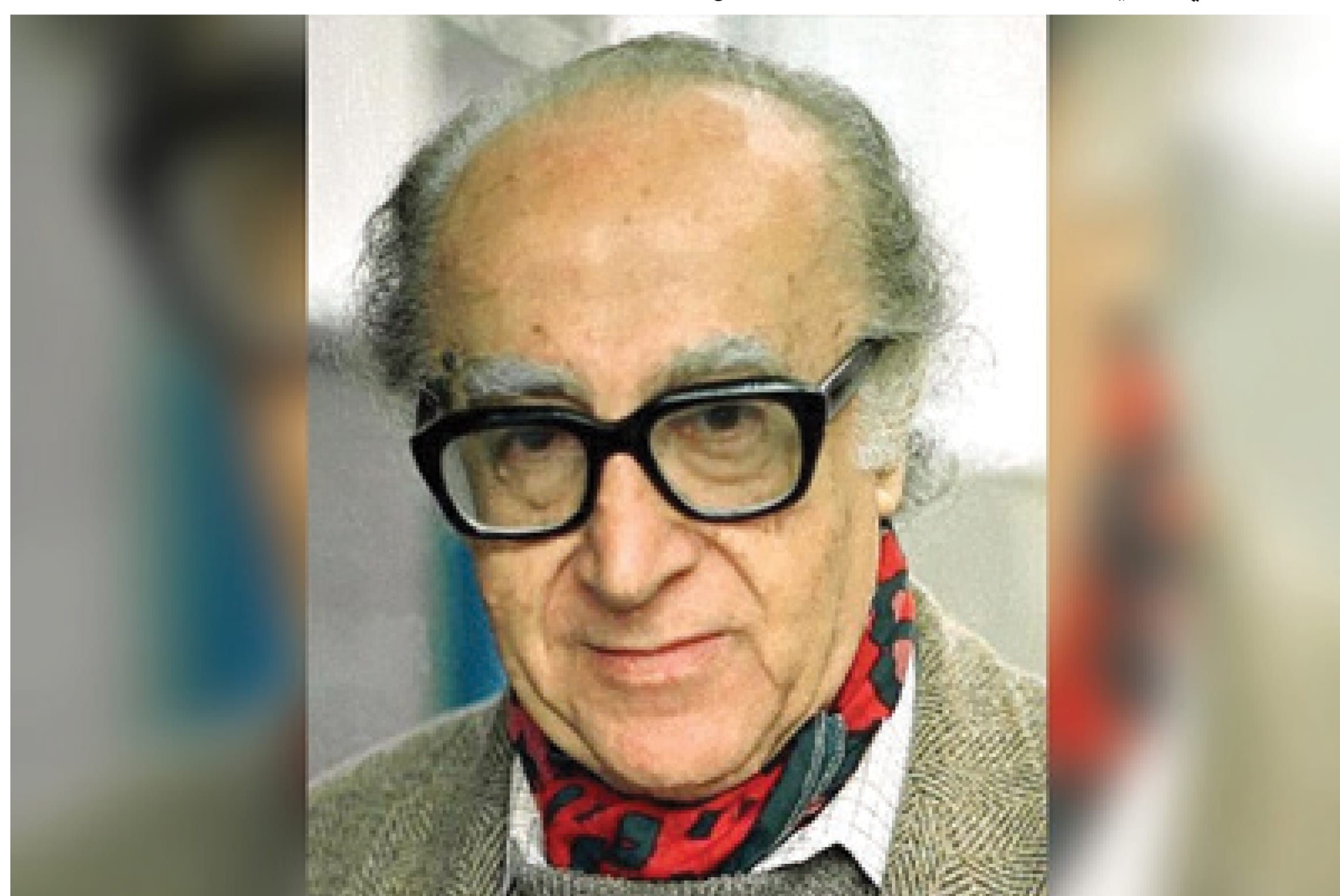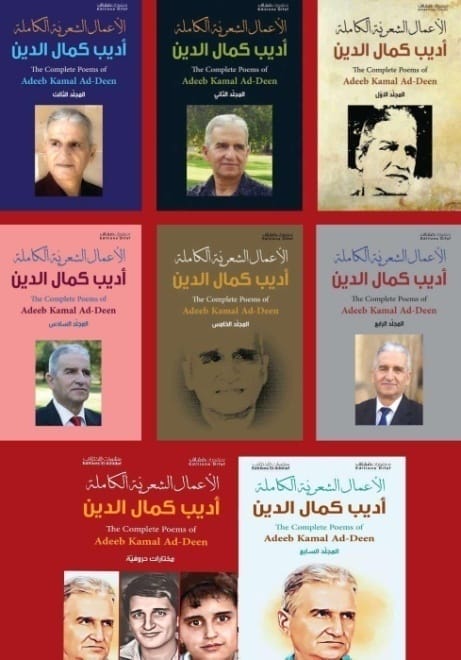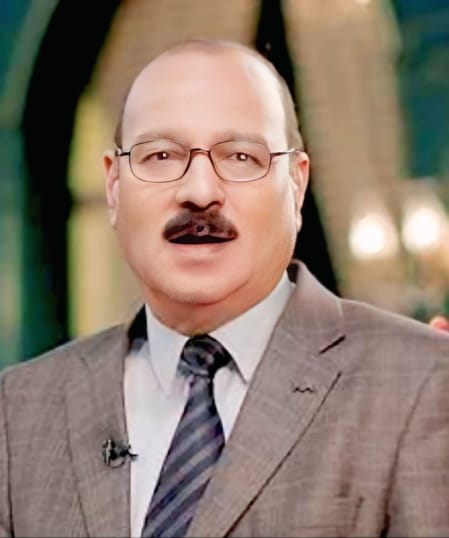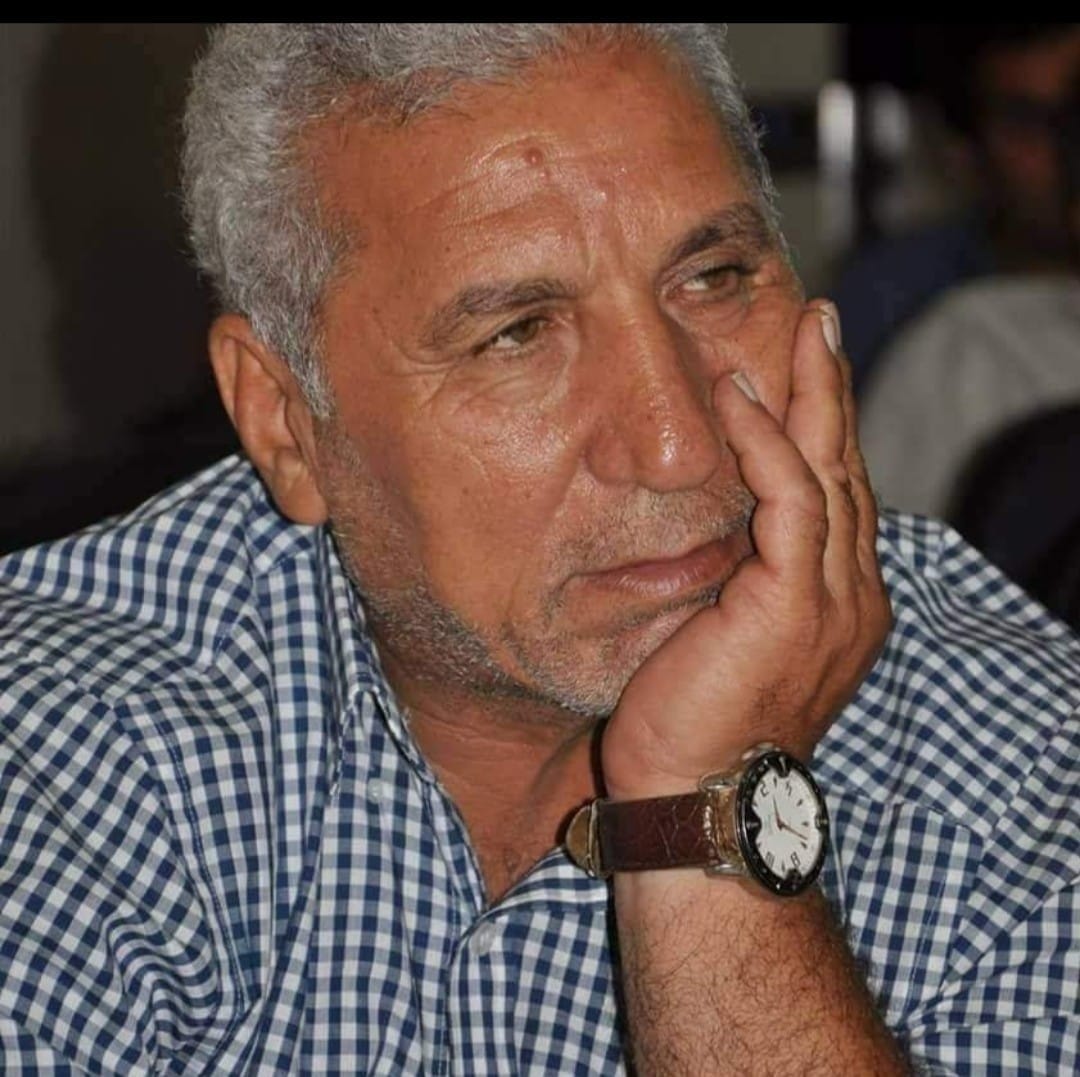الجــزء الثالث
ليس هذا حسب بل إن النواب قد فرك الصدأ عن الكثير من المفردات العامية المتروكة احتقارا ، والمستهجنة ترفّعا ، وجلا وجهها ، ووضعها على عرشها الدلالي الشعري المناسب في مملكة القصيدة . من كان يجرؤ على المراهنة على وجود موضع شعري لمفردات موغلة في يوميتها الرثة مثل :
* “نُبَگ” في البيت : ( ونُبَگ حچّام والحاجب نسر فارش جناحينه .. بوكاحه يطير )
* “خرخشت” في : (لو خرخشت گصبة ليل .. أفزن ، يا چبير البيت ) وهذه المفردة المستقاة من الاسم ”خرخاشة ” وهي أداة لتلهية الطفل الرضيع تصدر صوتا ” مزعجا ” وموقظا هو بالنسبة لفلاح مُحاصر في هور ” الغموگة ” مصدر انذار وتهديد ،
* أو كلمة “نشيش” المنسية حد اللعنة : (واليندفن بارض أهله ، عدل ، حي ….. يسمع الحنطة .. ويحس عروگها بصدره .. ونشيش الماي ) ..
* و “عثها” المأخوذة من فعل حشرة العثة الكريه والخطير حيث تنخر أشد الجدران بناء وتماسكا حتى تقوّضها بلا هوادة : ( وأگلكم روحي عثها الليل .. واختنگت عگبكم بيها عطابه )..
* أو (امضغبره) في : ( امضغبره .. وأچول من الچول .. وگامت بيها وحشة ليل وترابه ) .
وحين نراجع منجز السياب الشعري – رائد الحداثة الشعرية العربية في مجال شعر التفعيلة – لن نجد لديه توظيفا لمفردات فصيحة “قاسية” و “لا شعرية” إلا في أضيق الحدود ، ولم يكن لديه استعداد لإقحام المفردة العامية في بنية القصيدة دون أن “يلطّفها” من خلال إضفاء الصياغة الفصحى عليها .
وإن العنف النوابي الذي تحدثنا عنه سابقا ، والذي سميناه بـ ( العنف المُحبب أو الآسر ) والذي يختلف كثيرا عن عنف الجواهري وجيل الحداثة الذي أعقبه ، والذي سميناه ( العنف الدموي أوالوحشي) يسيطر على أجواء هذه القصيدة بشكل خاص ، فهي قصيدة مُقاوِمة ، شاغلها الإقتصاص من الطغاة من إقطاعيين وشرطة و”حوشية” في نداء و”تحشيم” هائل الوقع ينطلق من روح “اسعيدة” لاستثارة نخوة أخيها البطل “حچام” ، وهو رفيق النواب ؛ فلاح بسيط ؛ وإنسان مقاوم ؛ وبتلاشي الحدة الصوتية الصادمة لاستغاثة اسعيدة تنتهي ” الحركة ” الأولى من “ملحمة” مظفر هذه .
وهنا لابد أن نذكّر المتلقي بثقافة النواب الموسيقية فهو متذوق لروائع الموسيقى العالمية وهاضم لها . انعكس هذا التمثل المعرفي في تصميم البناء الفني لقصيدته في صورة “حركات” تشبه حركات السمفونية الكلاسيكية الأربع . تبدأ الحركة الثانية مع دخول المبدع بشخصه وصوته الذاتي ليشرح لنا مضمون “سالوفتنه” وهي الكلمة المرادفة لـ ” حكايتنه ” من أجل أن يوصّف لنا معنى التمهيد الملتهب المُضني الذي استغرق تسع صفحات من القصيدة – الملحمة ؛ فلم نعرف ما الذي سنواجهه بعد هذا التمهيد المُلتبس الذي لم تتضح هوية الراوي الحقيقي فيه إلا قبل لحظات – أبيات أخيرة ختم بها الحركة “الافتتاحية” للقصيدة ، لساحة الحركة الثانية – صحيح أنك تقرأ مفردة لغوية مُتسقة في انسجام لافت ومظهري على اللوحة النصية البيانية ، لكنها – هذه القراءة – تغرس في روحك المستكينة انطباعا شديد العمق حول “الحركة ” ، أول من أدخل موضوع ” الحركة ” في القصيدة الشعبية هو هذا المبدع الكبير الفذّ الذي كانت قبله القصيدة “سكونية ” و”راكدة” في طبيعتها العميقة ، وفي شكلها ، وفي تجاذبات قوى شخوصها ، وصراعات إراداتها ، فمنحها عمقها الدينامي وشكلها الحركي الصراعي . يقول الشاعر الذي دخل راوياً الآن :
( سالوفتنه عن فلاح مثل كل الفلح
إخته اسمها “اسعيده”
من هور الغموگة
بعد سنة اتعرّس
والمفارز طوگت بالليل أخوها
وچانوا الحوشية والشرطة 1000
والحرّة ما خافت
عمرها 17 سنبلة
صاحت : يا چبير الهور …. يا ابن الشلب … يا حچّام )