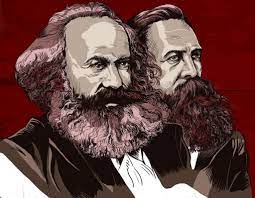تحقيق- وسيم باسم
منذ الفجر، تبدأ أم علي، زوجة الجبوري، عملها في المستنقع، فتغطس بقدميها في مياه البحيرات المالحة الساكنة، وإلى جانبها خمس فتيات من بناتها وأقربائها يجمعن الملح. وبحلول منتصف النهار، تكون حصيلة العمل ملء نحو سبعة أكياس، فيباع إلى التجّار ما يعادل دولاراً واحداً للكيس. وبعد أن ينتهي العمل، يصل الجبوري بسيّارته الـ”بيك آب ” المتقادمة إلى الموقع، فيحمل الأكياس على ظهر السيارة، إلى جانب زوجته والفتيات. هذا العمل موسميّ، ينتظر حلول الشتاء وهطول الأمطار الشحيح أصلاً في قضاء المحاويل ببابل، ثمّ ينتظر الصيف لتجفيف المياه. ومن هنا، فإنّ عمل الأسرة في استخراج الملح لا يتعدّى بضعة أسابيع بحسب ما أشار الجبوري في حديثه الّذي قال أيضاً: “فصل الصيف هو الوقت المناسب لاستخراج الملح، إذ يؤدّي ارتفاع درجات الحرارة لنحو خمسين درجة مئويّة، إلى سرعة تبخّر المياه من المستنقعات، ولا يتبقّى غير طبقة الملح الّتي يمكن إزالتها بسهولة أكثر”.وإنّ الممالح، هي اسم مستنقعات الملح في العراق، والمقصود منها البحيرات الراكدة المنشرة فوق سطح الأرض، يمكن رؤيتها بوضوح على أطراف المدن وفي الأرياف وحدود الصحراء، ويعمل فيها سكّان القرى والبدو كعمل جماعيّ تغرق فيه الأقدام والأيادي في المياه المتبقية بعد التبخر، والملح. وبسبب هذا الارتباط بملح الأرض في الكثير من مساحات العراق الجافّة، أطلق العقل الجمعيّ لقب “أولاد الملحة” على السكّان في وسط العراق وجنوبه، وهي مفردة مشتقّة لغويّاً من كلمة ملح، وتعني “ابن المرأة بسحنة تشبه الملح” في منطقة كيش – جنوبي بابل.
اعتادت أسرة الفلاّح أبو حسين على العمل في جمع الملح وبيعه، إلى جانب المهنة الأصليّة للأسرة، وهي الزراعة. لا تبعد بحيرات الملح سوى كيلومتر واحد عن مسكن أبو حسين، إذ يقصدها وأفراد الأسرة في المساء قبل غروب الشمس، مصطحبين معهم الأوعية والأكياس. وفي هذا المجال، قال أبو حسين، وهو يشير إلى بحيرة الملح الّتي أمامنا: “كومة الملح هذه هي حصيلة العمل في الأيّام الماضية. لقد تركناها لأيّام عدّة لكي تجفّ تحت أشعّة الشمس وتزول الرطوبة المتبقية فيها تماما، ثمّ نقوم بتعبئتها في علب كبيرة، ونتركها حتّى تزول عنها الرطوبة تماماً، ثمّ نقوم بتعبئتها في أكياس ونبيعها إلى التجّار”. ولقد عرض أبو حسين أمامنا أسفل قدميه المتشقّقة والمتأذّية بسبب الملح، حيث عمله لا يخضع لشروط السلامة المهنية، إلاّ أنّه قال باستسلام قدريّ: “لا يوجد فلاح عراقيّ لم تتشقّق أطراف يديه وأقدامه، بسبب الوسائل البدائيّة في الزراعة أو في استخراج الملح”. ذلك إن عملية جمع الملح هي عمل فردية لا تشرف عليه أي جهة صناعية او صحية. وكشف لنا حقيقة أنّ “هذا العمل القاسي، في مثل هذه الأوقات، ليس كثيرا، ويتوقف على الأيام المشمسة والشديدة الحرارة، أما في فصل الصيف فيرتفع المردود الماديّ إلى نحو مائة وخمسين دولاراً”. ومن الواضح أنّ هناك صعوبات في استخراج الملح وبيعه في الوقت الحاضر، بسبب اتجاه أبناء الأسر الريفية الى أعمال اقل مشقّة في مراكز المدن، إضافة الى صعوبة بيعه بسبب توفر المستورد من دول الجوار، فضلاَ عن مردوده الماديّ الضعيف، إلاّ أنّ هذه العمليّة كانت أصعب بكثير في الزمن الماضي، بحسب ما تحدّث به أبو عصام، الرجل البدويّ الّذي هاجر إلى مدينة المحاويل في عام 1970، وقال أيضاً: “كانت الجمال تحمل أكياس الملح وتتجوّل بين الأحياء في المدن لتبيعه على السكّان”. وأشار إلى أنّه كان قد فعل هذا بنفسه، وكانت عمليّة البيع تتمّ بالمقايضات أحياناً، حين كان يستبدل كيس الملح بسلع أخرى مثل الحلويّات وأواني الطبخ والصابون. لم يكن الملح، كسلعة مهمّة غريبة عن حضارات بلاد الرافدين، فقد استخدمه الآشوريّون كسلاح ضدّ الأعداء، كرمز لإهانة الشعوب التي تهزم امامهم، وذلك بنثره على رؤوس سكّان المدن الّتي يحتلّونها كرمز على اللّعنة التي حلّت بهم. ويروي الفيلسوف والمؤرخ والكاتب أمريكي ويل جيمس ديورانت (1885 – 1981)، في كتابه الكبير “قصة الحضارة” أنّ الملك الآشوريّ آشوربانيبال قال في هجومه على عيلام: “لقد نشرت الملح والحَسَك لأجدّب الأرض”. وتروي ملحمة أتراحسيس البابليّة، كيف طغى اللّون الأبيض على الحقول في بلاد الرافدين القديمة، بعد أن تسرّب الملح إلى التّربة، في دلالة على ظاهرة الملح في ارض بلاد الرافدين منذ الأجيال السحيقة. ورغم كلّ هذا التاريخ للملح في بلاد الرافدين، إلاّ أنّ “صناعته ما زالت بدائيّة”، بحسب ما أشار إليه التاجر والصناعيّ العراقيّ عصام كاظم، الّذي يستورد الموادّ الغذائيّة من إيران، ومن ضمنها الملح، وقال: “السوق العراقيّة حافلة بالملح المستورد من دول الجوار، ممّا أثّر حتّى على عمليّات استخراجه البدائيّة الّتي يقوم بها البدو والفلاّحون، إذ انحسرت كثيرا، بسبب المنافسة لصالح بضاعة الملح الأجنبية، فتسبّب ذلك بفقدانهم لهذا العمل الّذي لا يدرّ عليهم، إلاّ مبالغ بسيطة، ما يعني الخسارة لهم مقابل الجهد الشاق المبذول”. وتحدّث الباحث الإجتماعيّ والخبير الصحيّ حسن الكلابي في مستشفى الحمزة الغربيّ، وهي منطقة يعيش على أطرافها فلاّحون وبدو، عن المصاعب الصحيّة الّتي يعاني منها أولئك الذين يجمعون الملح من المستنقعات، فقال: “يعانون من تشقّق الجلد وجفافه، إضافة إلى إصابات بأمراض الروماتيزم، بسبب تغطيس أقدامهم لفترة طويلة في المياه المالحة”. وأشار إلى”أنّهم لا يرتدون كفوفاً في اليدين أو واقيات في القدمين للحيلولة دون إصابتهم”. وفي الحقيقة ان هذا اهمال “شخصي” لصحتهم بسبب غياب الوعي بخطورة ما يقوم به على الصحة. وفي حين رأى حسن الكلابي أنّه بإمكان الكثير من الممالح أن تتحوّل إلى مصحّ لعلاج الأمراض الجلديّة، دعا إلى تطوير وسائل الإنتاج لتوفير الملح كمادّة غذائيّة يكتفي منها العراق محليّاً. كما يمكن استخدامه في الصناعات الدوائيّة والغذائيّة الأخرى مثل مضادات الحموضة والأملاح الطبية والدباغة وصناعة الألبان واللحوم. إنّ استثمار الملح في تطوير الاقتصاد يبدو أمرا ملحا اذا ما عرفنا ان العراق يستورد سنويا بمبلغ 250 مليون دولار ملح الطعام بينما توجد على أرضه أكبر مملحة بالعالم.


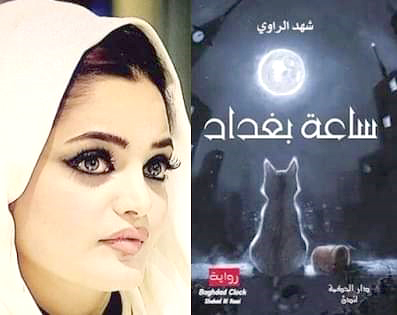
_1617644865.jpg)