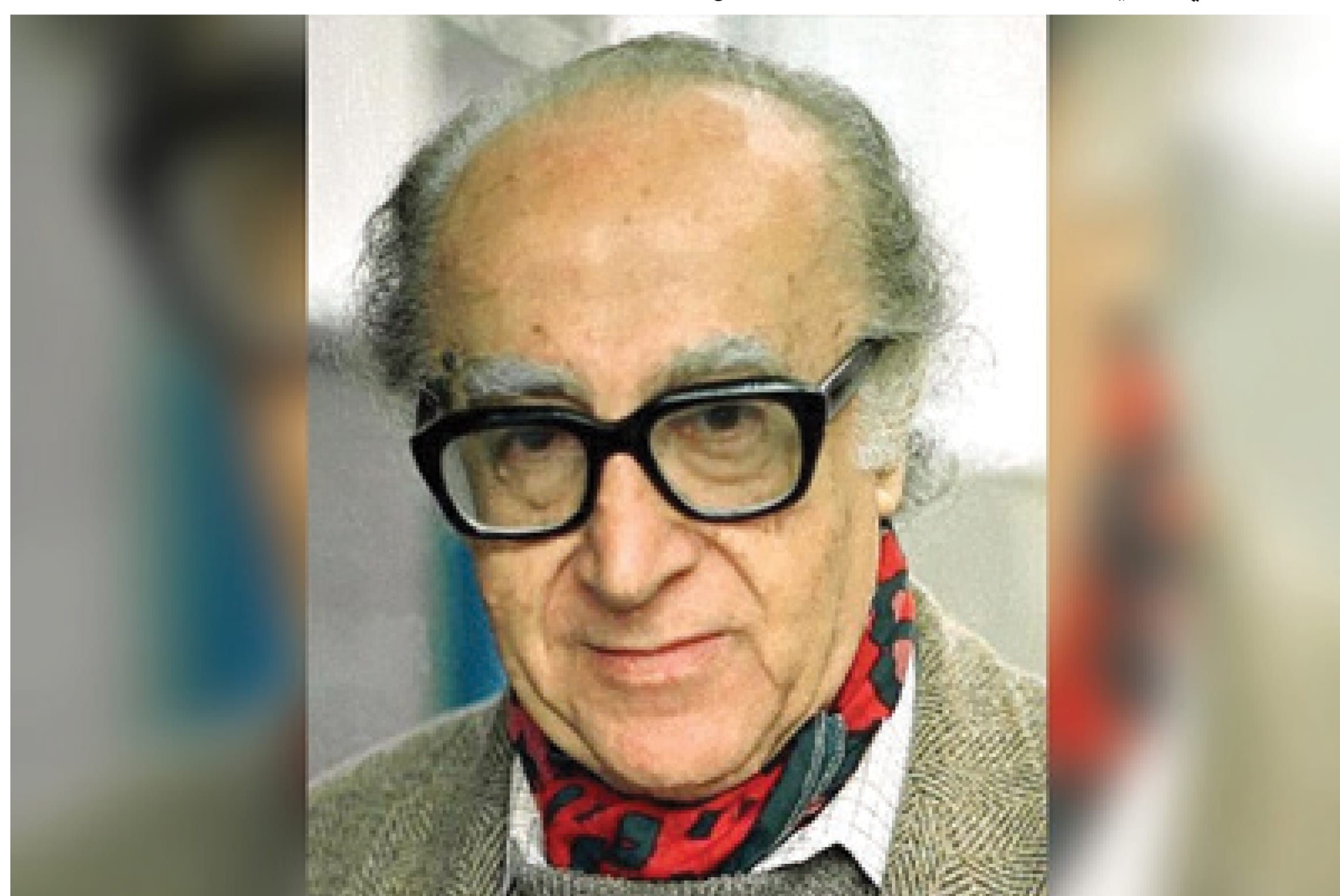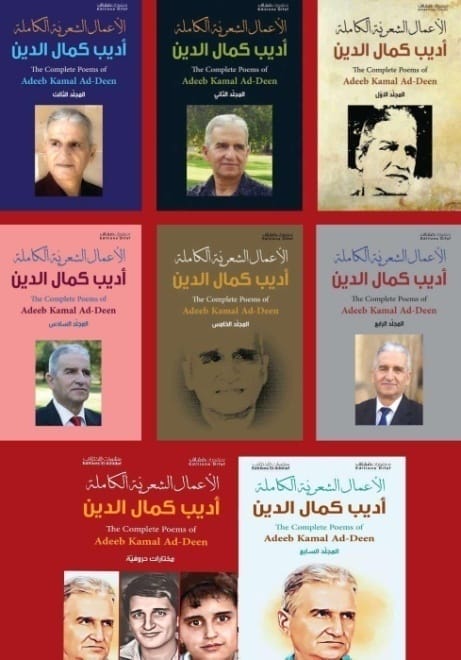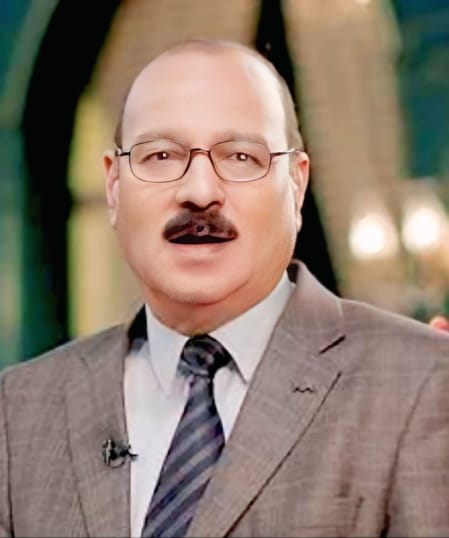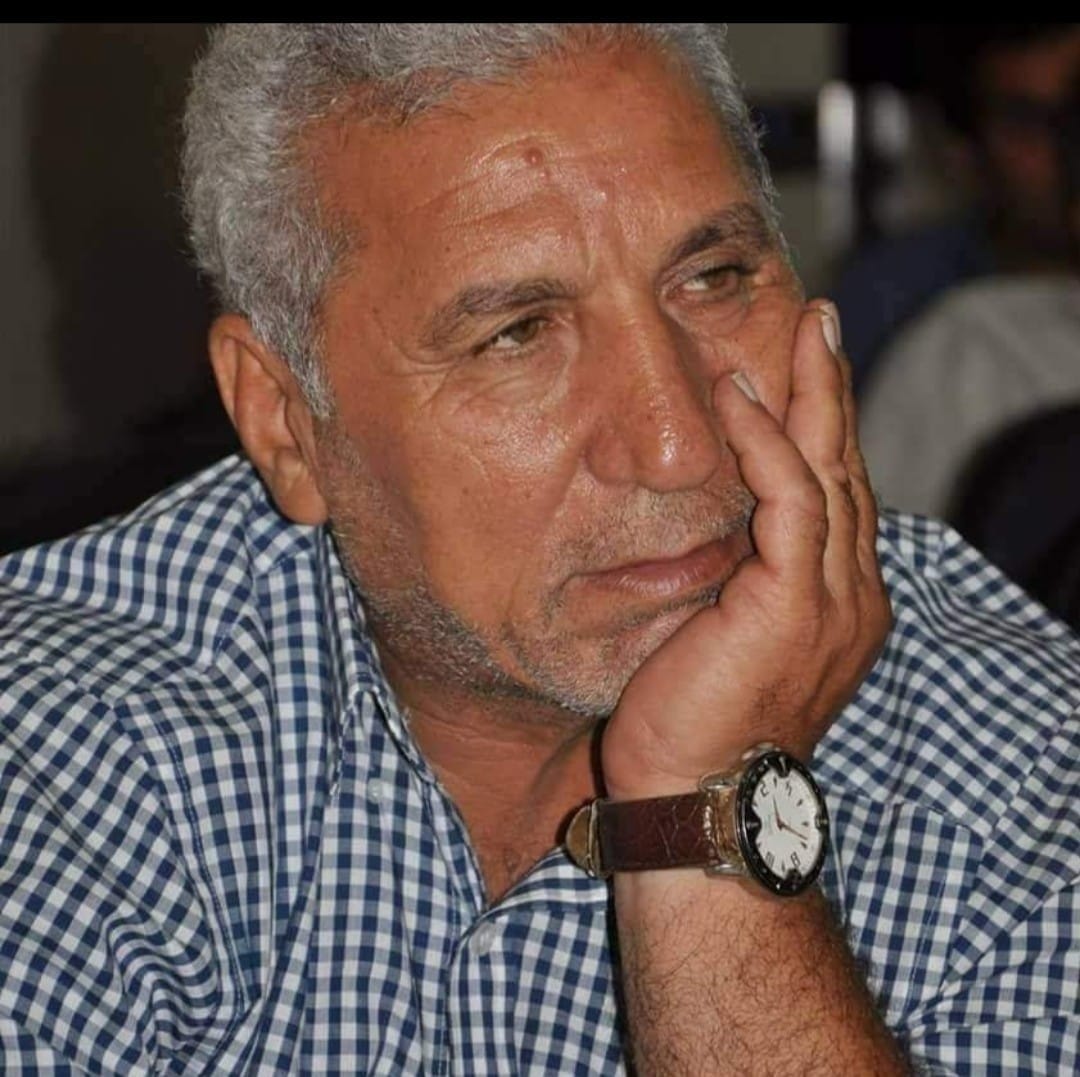يحاول البحث أن يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب الحركة الصوفية ، المتمثل بالجانب الثوري ، إذ إن المتابع للحركة الصوفية يستطيع أن يلحظ ملمحا ثوريا بارزا عند بعض أعلام التصوف كالحلاج ، ويستند البحث إلى مقولات المفكر هادي العلوي عن الجانب الثوري في الحركات الدينية ، وكذلك ما ذهب اليه الدكتور عبد المحيي اللاذقاني عن الحلاج ودوره في ثورة القرامطة . ويحاول البحث رسم مقاربة ادبية تتوخى استقراء البعد الصوفي الثوري عند الشاعر المناضل مظفر النواب ؛ لأنه قد استخدم رموز الصوفية بوصفها رموزا ثورية في محاولة لتأصيل فكرة التصوف الثوري من خلال قصائده ، فيعرض البحث مصطلح ( التصوف ) وأصله ، في محاولة لتقصي ملامح هذه التجربة المعرفية التي تعتمد المعرفة القلبية الموازية للمعرفة العقلية كما يرى المتصوفة ، كما ويسلط البحث الضوء على مقاربة التصوف للفلسفة ، والشعر باعتبار ان كليهما ينهض على تجربة تأملية ذاتية مستقاة من تخيل عميق يسعى إلى بلوغ أقصى درجاته في التجلي والإلهام.
اهم الاخبار
ثقافة شعبية
مظفـــر النـــواب أنموذجـــــاً
- 11 يناير, 2014
- 36 مشاهدة
م.م احسان العجلان / الجزء الاول
التصوف الثوري ، مظفر النواب انموذجا
ينطوي الحديث عن التصوف في الإطار العلمي على مفارقة جلية تتمثل في البون الشاسع بين لغة المتصوفة من جهة ولغة البحث العلمي من جهة أخرى . فالتصوف يعنى بالباطن ويعبر عنه بلغة تتجاوز الأشياء وظواهرها في رحلة معرفية تتوخى الوصول إلى المطلق ، عبر تخطي العالم وآليات إدراكه على السواء، إذ تتجاوز الحواس ويحجم دور العقل، فالعقل عاجز والعاجز لايدل إلا على عاجز مثله ، وهذا التحجيم لدور العقل لدى الصوفية لم يكن احتقاراً له ولإمكاناته بل لعظمة المطلوب وشرفه ، ومطلوب الصوفية الله جل وعلا لذا فإن العقل لديهم آلة للعبودية ، لا للإشراف على الربوبية . ومن هنا كان التصوف عصياً على التعريف فقد جمع نيكلسون ( 78) تعريفاً للتصوف يغلب عليها الجانب الأدبي والبلاغي دون التحديد العلمي الدقيق للمصطلح، ومنها:
أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة و أن لاتملك شيئاً ولايملك شيء و الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق. غير إن التصوف بالرغم من تموج المصطلح وأصله وباطنية الآليات وغموضها ـ يكشف عن خطوطه العريضة بصورة تتيح للباحث تتبعها ومحاولة إدراك مضامينها. وهذا الكشف لايتأتى من الصوفية ذاتها ، بل من الغاية التي تسعى إليها قلبيا، والمتمثلة بالوصول إلى حقيقة الوجود ومعرفة الله سبحانه معرفة ذاتية تعتمد على التجربة الشخصية للمتصوف دون سواه . والمتصوف في بحثه عن الله يخوض تجربة معرفية عميقة عمادها علم القلوب الذي يفيض على النفس معرفة تنطوي على استعداد الإرادة لتلقي الحقائق الروحية، وتأتي هذه الرحلة البحثية للإجابة عن تساؤل مستحيل يهدف إلى التماهي مع الغيب بعد أن عجز العلم عن ذلك ، والمعرفة المتحصلة من هذه الرحلة تكمن في حضور الذات الإلهية الخالقة والمدبرة والعارفة حضوراً اتصالياً بالوجــود (( فالله صوفياً ليس الواحد إلا لأنه الكثير . انه من الوجود (( النقطة العليا)) .. النقطة التي يتوحد فيها ما نسميه المادة وما نسميه الروح. .. فهو ليس الواحد الذي يخلق الوجود ، من خارج ودون اتصال به ، وإنما هو الوجود نفسه في حركيته ولا نهايته ليس في السماء ، وليس في الأرض ، بل هو السماء والأرض معاً ، متحدتين )) وبهذا تطرح الصوفية تساؤلاتها داخل رحلتها الروحية لاخارجها، ولأنها تصفية للنفس ومجاهدة لها وانتقال بها من حال إلى حال فإنها في الآن ذاته تطرح الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال الوصول إلى المقام المتوخى. من هنا فإن الصوفية تحتوي على معرفتها الخاصة التي يصل إليها الصوفي مباشرة بغير وسائط من مقدمات أو قضايا أو براهين فمعرفتها معرفة فوق عقلية،وهي من مواهب الله وكرمه وفضله ولاتاتي إلا بعـد طهارة القلب وتزكيته . وهذه المعرفة تناظر ما يعرف بالغنوصية التي تعني التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا وتذوقها تذوقاً مباشراً بأن تلقى فيه القاءاً ، لأن الإنسان لايستطيع بقواه العادية الوصول إلى المعرفة العليا، ولهذا يحتاج إلى مصدر عال لايصاله إليها وبهذا لاتستند المعرفة إلى استدلال وبرهنة عقلية بل تُحصَّل بالاتصال عبر تطهير القلب . من هنا تظهر الصوفية بوصفها متمماً معرفياً يعتمد القلب في تقصي باطن العالم، إزاء الفلسفة التي تعتمد الحواس لفهم الظاهر، والصوفية تكاد تكون مرحلة متقدمة للمعرفة لأنها ترى في حصر وسائل المعرفة الإنسانية في مصدري الحس والعقل حيفاً وقصوراً لايشمل الناحية الروحية في الإنسان، التي تعد البصيرة جوهرها. فالفلسفة والصوفية وإن تباينتاً في آلية تحصيل المعرفة إلا إنهما تلتقيان في الغاية المتوخاة، وهي محاولة فهم الوجود وفك طلاسمه، وبهذا تظهر أهمية الصوفية لأنها تجربة تصل الإنسان بذاته العميقة، وبما يتجاوز الواقع الذي يحجبه عن هذه الذات. وهذه المقاربة التي تنبثق من الصوفية تجاه الفلسفة تنطوي في الآن ذاته على مقاربة أخرى تجاه الشعر ، إذ إن العلاقة بين التصوف والشعر علاقة وطيدة على اعتبار أن كليهما ينهض على تجربة تأملية ذاتية مستقاة من تخيل عميق يسعى إلى بلوغ أقصى درجاته في التجلي والإلهام . إن التصوف والشعر يحاولان الكشف عن الحقيقة وتجاوز الوجود العقلي للأشياء عبر استبطان منظم للتجربة الروحية. والمعرفة الحقيقية لدى الصوفية هي معرفة الشيء من الداخل بإلغاء المسافة بينه وبين العارف وإتاحة تحقيق الذات له بمعرفة الوجود بالشهود حسب المصطلح الصوفي وهذا ما يقترب حد الاندماج مع المعرفة الشعرية بوصفها الحدس بما لانراه عبر معرفة بدئية يندغم فيها الأنا بالوجود والأنا بالنحن. وبعيداً عن المعرفة وآليات تحصيلها ، تلتقي الصوفية بالشعر في بعد آخر يتمثل في (( سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالاً من عالم الواقع ، ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفضاعة الواقع ، وشدة وطأته على النفس ، وصبوة الروح للتماس مع الحقيقة التي تعذب كياننا )) . إن الصوفية شأنها شأن الشعر، تنطوي على ثورتها الخاصة الباحثة عن يوتوبيا بعيدة المنال أو (( على حد تعبير السهروردي المقتول : ناكجا اباد = البلد الذي لايوجد في أي مكان )) فالصوفية قد تجاوزت أسوار الانعزال والانفراد عن الناس وتخطت سلبيتها الداعية للابتعاد عن الدنيا وواقعها بما فيه من متناقضات سياسية ودينية واجتماعية على السواء، عبر ندائها بالولي أو القطب الملهم الذي يمتلك الحق في إدارة شؤون الدنيا وتدبير أمر الرعية، وبهذا تحولت الصوفية من حركة باطنية تهدف إلى الارتقاء بذات الإنسان عبر الاتصال المباشر بالله سبحانه، إلى حركة ثورية تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية وسياسية تمس واقع الإنسان في هذا العالم بصورة مباشرة وجمعية . وقد تجلى هذا الأمر عند الحسين بن منصور الحلاج (قتل 309 هـ ) الذي اختصر في شخصيته صورة التذمر الشعبي العام ضد السلطة، و بلغت الصوفية على يده أوج اندماجها بالمجتمع ، من خلال النضال والدفاع عن حقوق الخلق التي تهضمها السلطات ، إذ أخذت الحركة الصوفية أبعادها (كشكل) من أشكال الرد العفوي على استبدادية الحاكم : الاقتصادية والاجتماعيـة والإيديولوجية . مما تقدم فإن العلاقة بين الصوفية والشعر تبدو جلية وبصورة خاصة عند شاعر مناضل وثائر كالنواب . فالصوفية إذ تنطلق من نقطة مجابهة الواقع الإقطاعي وإيديولوجيته المناهضة للتقدم الاجتماعي والفكر الإنساني، فهي إنما تنطلق من ذات النقطة التي انطلق منها الشعر المعاصر ـ كشعر النواب ـ في مهاجمته للأنظمة المتخلفة التي سعت إلى طمس ذات الإنسان وسحق أفكاره وطموحاته من خلال إيديولوجياتها الشمولية التي تقصي الآخر ، ولا تؤمن بغير وجودها .