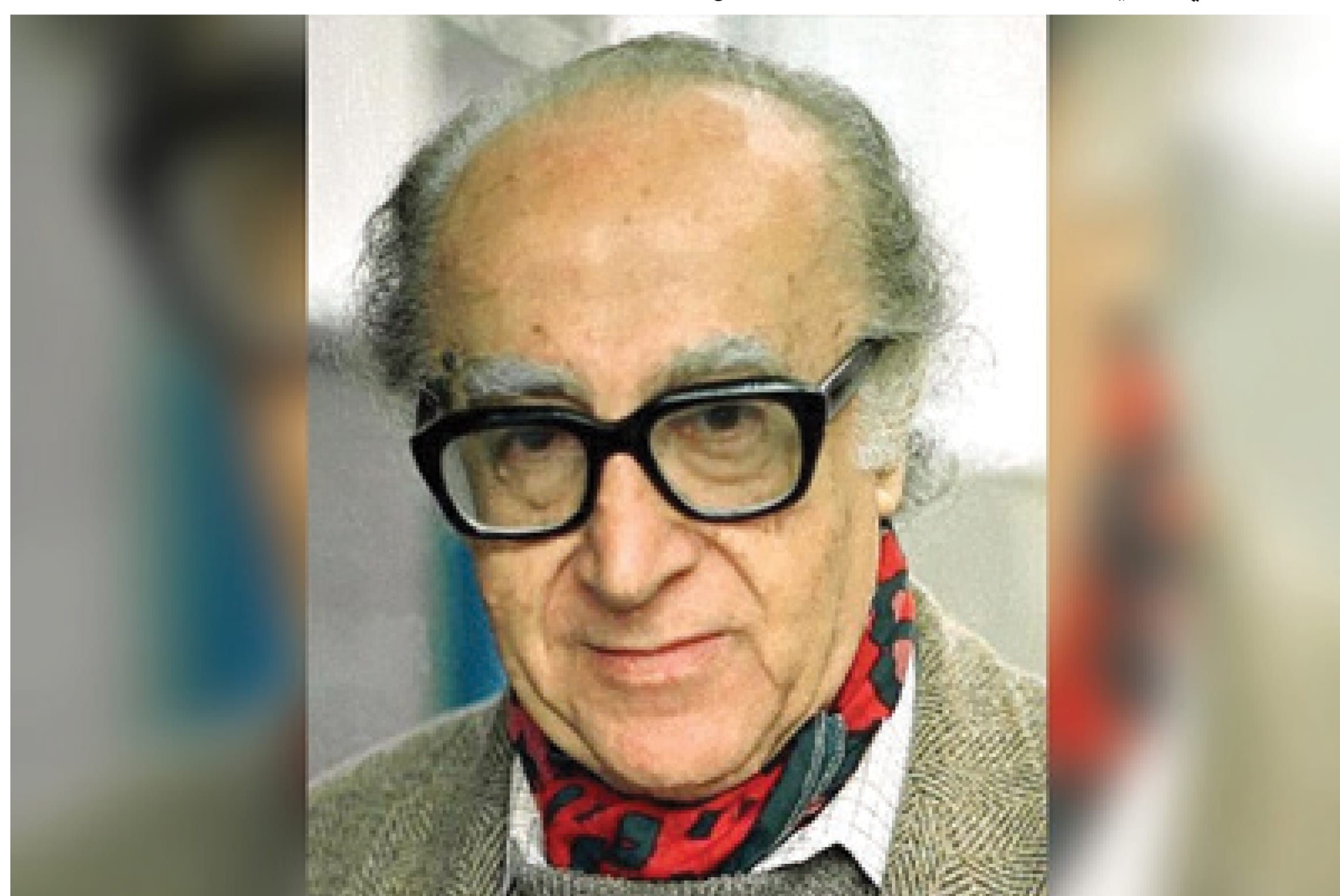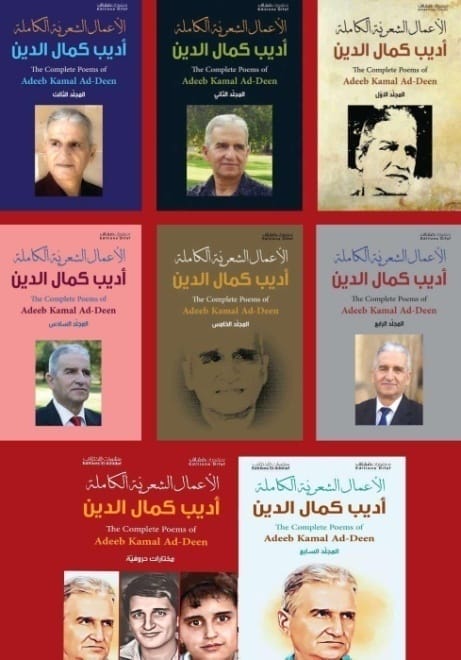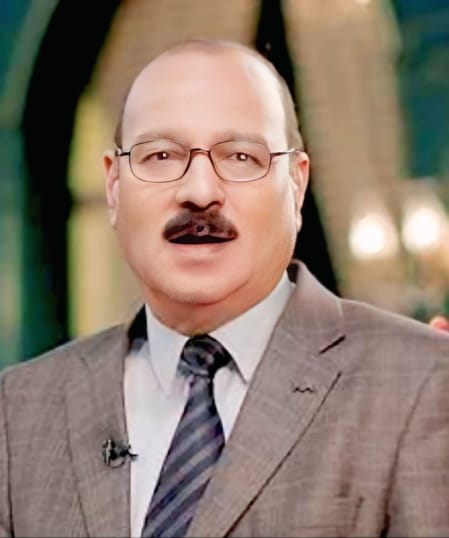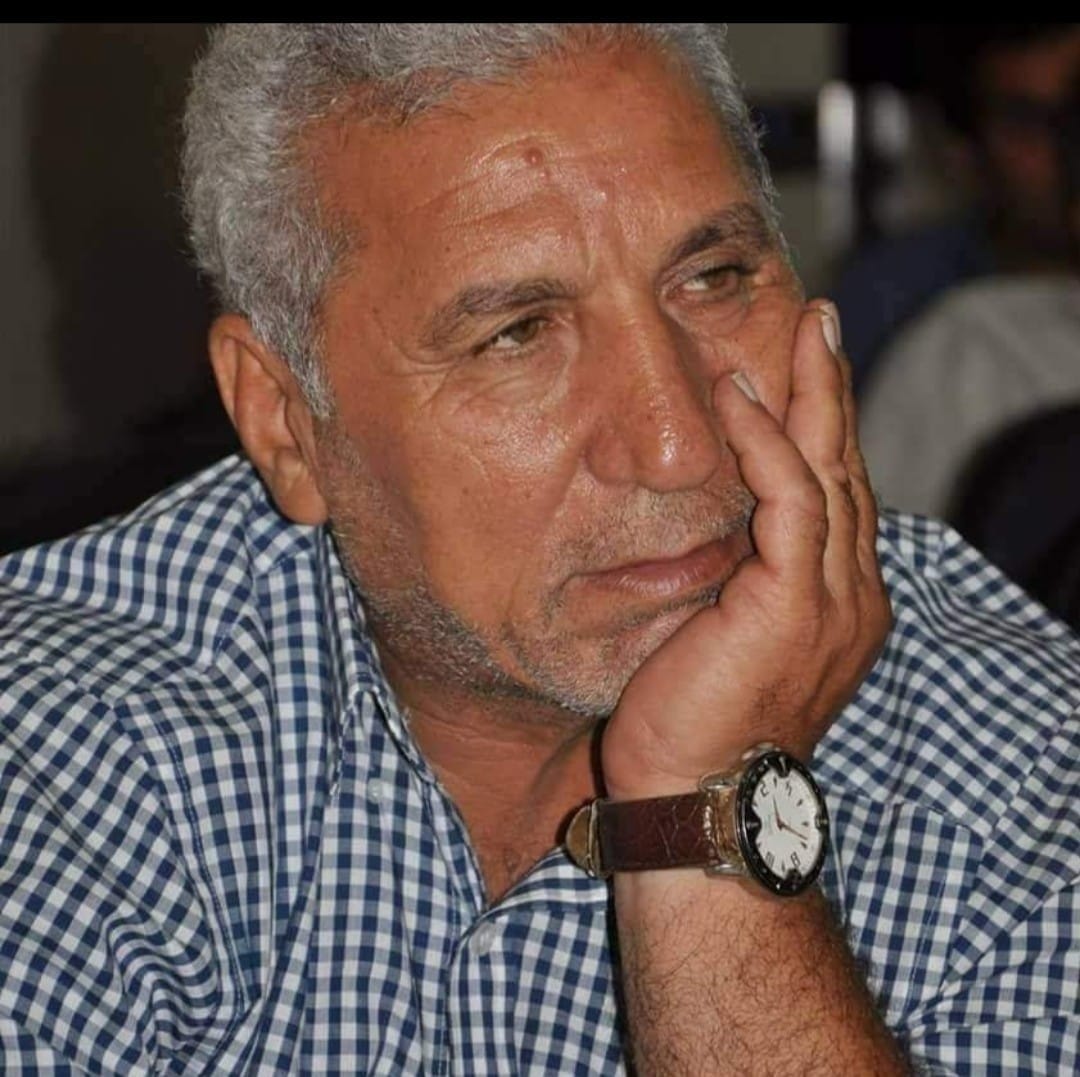حسين الهنداوي / الجزء الثاني
ان سعدي وريث وفيّ ودؤوب لكل تلك الثروة الغنائية الاصيلة التي يمثلها غناء البادية العراقية، فانه وريث كبير ووفي كذلك لكل ذلك التراث الخصب والخبرات العراقية في الموسيقى والشعر الشعبي البدوي والجنوبي، كما تشهد على ذلك مؤلفاته العديدة بدءاً من “أغاني الجوبي في اعالي الفرات” اطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1984 وانتهاء بدراساته ومقالاته ومحاضراته الكثيرة عن الغناء البدوي والشعبي والفولكور المنشورة وغير المنشورة.
وروى لنا الصديق ملهم النقيب ايضا ان سعدي الحديثي أصطحبه مرة الى منطقة (ابو غريب) لزيارة شاعر وراوية بدوي طاعن في السن اسمه (ابو عيادة) كان بمثابة الحافظة التي يستقى منها الكثير من (الگصيد) والاخبار والسير. “وكان اللقاء طويلا رغم تقدم (ابو عيادة) في السن بل ان حافظته بدت عجيبة الى حد اثار شجون سعدي للغاية. وعند عودتنا الى بغداد ركبنا في سيارة أجرة، وكنا الوحيدين فيها مع السائق. ودون ان يطلب منه احد الغناء سمعت سعدي يدندن مع نفسه بقصيدة طويلة سمعها من ابو عيادة، فأذا بسائق السيارة يهتز طربا فيما راح سعدي يتحفنا بمقطع اثر آخر طوال الطريق الى بغداد كما لو ان حاجة داخلية ماسة دفعته الى ذلك. ولقد كانت برهة السفر تلك لوحة غنائية رائعة رغم عفويتها سمعت فيها من الشعر البدوي ما لم اسمعه قط من قبل”.
اما القصيدة تلك التي يختلف الباحثون والرواة بشأن نسبتها الى شاعر بذاته فتعد اليوم بين اجمل الشعر البدوي الحديث ومطلعها:
نطيت رجمٍ وثاري الليل ماسيني
بْدّيَرْ غربه يْعَلّي السيل ما جاها
اضحك مع اللي ضحك والّهَمْ طاويني
طَويَة گْربْ الطلَبْ لو وشَّلو ماها
علامِج ما تِذِرفينْ الدمع ياعيني
على هَنوفٍ جِديد اللبسْ يزهاها
هبتْ هبوب الشمال وبردها شيني
ما تِدْفي النار لْيا حِنّا شعلناها
ان الوصول الى هذه الاصالة المتميزة في الاداء والذوق والمؤالفة والتوثيق الشعري والموسيقي التي لدى هذا الفنان تعود بلا شك الى ما فيها من خصال تلك الروح البدوية غير المستقرة في اي مكان او في اي زمان ربما، لكن الغائرة الجذور والجروح في عالمها الخاص الوجودي جدا. وسعدي الحديثي المترعرع في عائلة دينية يخبرنا بانه بدأ وعيه بالعالم الذي يحيط به بتقليد جده في كل شيء، وذلك منذ الثالثة من العمر عندما بدأ بمحاكاة طريقة تلاوته للقرآن الكريم وطريقة صلاته وتمتماته وكيفية نطقه الحروف واداء الگامات. ذلك الجد لم يكن الوحيد في التأثير عليه لكنه “كان هو الاقرب” إلى روحه وصاحب الاثر الابلغ في صقل مواهبه الصوتية والذوقية ونزوعه الى التصدي لتقلبات الريح والتقاليد والقيم البالية. وكما لا يمكن الكلام عن سعدي دون الكلام عن مدينة حديثة، لم يعد ممكنا الكلام عن حديثة دون الحديث عن ابنها الموهوب هذا، حامل طيبها الى كل العراق والعالم. ففي تلك المدينة الفراتية التي تشبه تشكيلة من جزر، والعذبة الهواء بالفطرة، كانت نشأته الفنية الاولى حيث يخبرنا بأن البيت الذي نشأ فيه حتى الخامسة من عمره كان له دور في تكوينه: “كان ظهر البيت إلى الصحراء وواجهته على حقل من النخيل وبعض الاشجار وهناك ما بين نهر الفرات والحقل نحو 400 متر، وكان عندنا حوالي 40 رأس غنم فهذه حياتنا وفي هذا الجو عشنا”. وفي حديثة بدأ تعلم المراقبة والانصات ثم وجد نفسه يحفظ كماً هائلاً من الاغاني الفلكلورية ومن القصيد البدوي، كما زادت قدرته على الغناء وعلى التعبير. وعن نشأته الاولى، سيخبرنا سعدي لاحقا ان مواهبه في التلاوة والغناء بدأت تظهر جلياً بعد التحاقه بالمدرسة الابتدائية فصار يكلف بالادوار المسرحية التي تتطلب الغناء، وكذلك بالغناء في الافراح العائلية، فيما غدت فصول الإنشاد الديني في الاحتفالات الدينية، وخاصة في تكية جده الشيخ خيرالله في ليالي الجمع، حقلا خصبا لتعلم الغناء وضبط الاداء وحفظ الكلمات.. ثم جاءت الطلعات إلى البادية والاستماع الى شعراء وعازفي البادية لتسمح بإثبات ملكته الذوقية والغنائية حيث بدأ كما يقول “أغني كما يغني اهل الريف: اضغط على حنجرتي واخرج صوتاً يطرب له المحيطون بي ولكني تعلمت من البدو كيف يخرجون الصوت من الرأس وهم يؤدون العرضة وكيف يخرجونه من الصدر وهم يغنون مع الربابة وفي اغاني “السامري”، وحين جئت إلى بغداد وكانت لغتي الانكليزية قد تطورت ففتحت لي عالماً جديداً ووقعت على كتب علمتني كيف أُطور لياقتي الصوتية، فدخلت مرحلة جديدة رغم تأخرها رفعت من قدرتي وميزتني عن معارفي من المغنين بل وعن الكثيرين من المحترفين في الغناء العراقي”. في هذه المرحلة الجديدة، صار هذا الفنان يتدفق كنبع صحراوي مفرد وثر ودائم مضفيا بهذا تواصلا لم يكن موجودا من قبل في اغاني البادية العراقية. ومعه باتت انغام “كل الهلا بْحبَيبي الجاني زْعَلانْ، طابجْ ورده وخزّامَه والوسطْ عْرانْ” و” ولِچْ عَرنَه ولچ خانه، يَوَلّي وينْ ربيانه”، و” يا بو چَرِدْ ناعورْ چردَكْ دِ ديره، مثل الرمَد بالعين عشگْ الزِغِيره”، و”ياعين مْولَيتينْ وْعينْ موليه”، و”عَلّماني يُمَّه الماني”، و”عالميجَنَة وعالميجنة” وعشرات النصوص الغنائية، البدوية االمحضة في الاصل، من مكونات ذواتنا العاطفية المدينية، هذه المرة، الاكثر نبضاً وحميمية بعد ان كانت مجرد تراث متوار او ناءٍ او مجهول. وفن سعدي الحديثي ثري وأصيل ليس من الزاوية الجمالية والفنية وحسب انما من الزاوية السياسية اذ من خلال تأمله نتأمل شجون مرحلة تاريخية كاملة من حياة العراقيين والعراق الحديث بكل ما حفلت به تلك الحقبة من عطاء وبطولة وآلام وانقلابات لا سيما وإن جزءا كبيرا مما يجب ان يقال عن تلك الحقبة اضحى قيد النسيان بل التشويه والاهمال المنظم احيانا من قبل جماعات طارئة او غريبة عليه او معادية له وتخشاه بالتالي كمرجعية حضارية وانسانية. فقصائد مظفر النواب وكذلك أغاني البادية العراقية بصوت سعدي الحديثي تظل شاهدا على روعة عراق الستينيات التي سرعان ما ستنطفئ جذوتها الخلاقة تلك تحت ضغط سموم ودمامة وهمجية البطش البعثي الذي داهم العراق اثر انقلاب عسكري في 17 تموز 1968. بيد انها تظل شاهدا ايضا على ان العلاقة بين هذا الفنان والشاعر مظفر النواب لم تكن مجرد علاقة مغني بمؤلف كلمات انما كانت علاقة انسانية صافية.. فسعدي الحديثي كان مناضلا يساريا عانى هو ايضا وطويلا الاعتقال والاضطهاد والنفي والسجون وهو في مقتبل العمر. وهي اهوال لم نكن جربناها بعد آنئذ ولم نكن نعرف عنها سوى ما كان يصلنا عنها في القصص والاحاديث. ومن المناسب أن اذكر شيئاَ عن نوعية المحاكمة التعسفية التي ألقت بسعدي الحديثي في سجن “نقرة السلمان” الصحراوي مطلع 1964، كما رواها مرة لي بنفسه:
“تبرع بعض زملائي الطلبة والقوا القبض عليَ داخل كلية الآداب، وهي حكاية طويلة.. اما ما جرى اثر ذلك حتى الوقوف أمام الحاكم في قاعة المحكمة فكان ما يلي: بعد سبعة عشر شهراً من التوقيف والتحقيق والنقل من موقف إلى موقف ومن سجن إلى سجن والتعرض إلى اصناف الإهانات والضرب فقط – وليس التعذيب كما جرى لغيري– تمت إحالتي إلى محكمة عسكرية بتهمة الإنتماء إلى منظمة محظورة وعقوبتها القصوى ستة أشهر! وبعد الأستجوابات الروتينية المعروفة تطورت المساءلة وتركزت على ثلاث أسئلة لا غير: هل مصطفى البارزاني وطني أم عميل؟ وهل الحزب الشيوعي وطني أم عميل؟ وهل عبد الكريم قاسم وطني أم عميل؟ كان جوابي هو “لا أدري” في الحالات الثلاث ولم أكن مجابهاً أو متحدياً قط، لكنني كنت صادقاً تماماً، إذ رغم موقفي المختلف مع تلك الجهات الثلاثة، لا دليل يدفعني الى التشكيك بوطنية أي منها. الا ان جوابي ذلك فجر غضب الحاكم الذي انتفض ممتعضا خاصة عندما رفضت الطعن بالبارزاني، وراح يضغط علي كي أقول عن الاخير بأنه عميل، ثم سألني بنبرة غاضبة هازئة: وهل انت عربي؟، قلت: نعم سيدي. قال وكيف تثبت لي انك عربي؟ قلت: أمي وأبي عرب أقحاح ونسبي الى بني هاشم من قريش، وأنا أعشق لغة العرب وأحفظ شعرهم الفصيح وقصيدهم البدوي وأعتز بالتراث العربي وأفخر به لأنه تراث أجدادي. وهنا ارتفعت حدة غضبه ليسألني صارخا: كيف اذن إن كنت عربي وتجهل إن كان البارزاني وطنياً أم عميلاً؟! قلت له أتريدني أن أشرح لك كيف؟ قال نعم، كيف؟! قلت: في العهد الملكي وصفوا البارزاني بالعمالة والطرد إلى خارج العراق، ثم وجدناه بعد أكثر من عشر سنوات يعود إلى الوطن ويستقبل كرمز وطني إثر ثورة تموز 1958، وبعد فترة قصيرة راحت حكومة عبد الكريم قاسم تصفه بالعمالة وبدأت الحرب مرة أخرى، ثم سقطت حكومة قاسم وجاء البعثيون بانقلابهم الدموي وعاد البارزاني وطنياً معززاً مكرماً، ثم في أقل من ستة أشهر تغيرت الدنيا فوصمته سلطة البعث بالجرم والعمالة. وعندما حدث انقلاب عبد السلام عارف عاد البارزاني وطنياً من جديد، ثم ها هو الآن عميل كما تقول الحكومة..