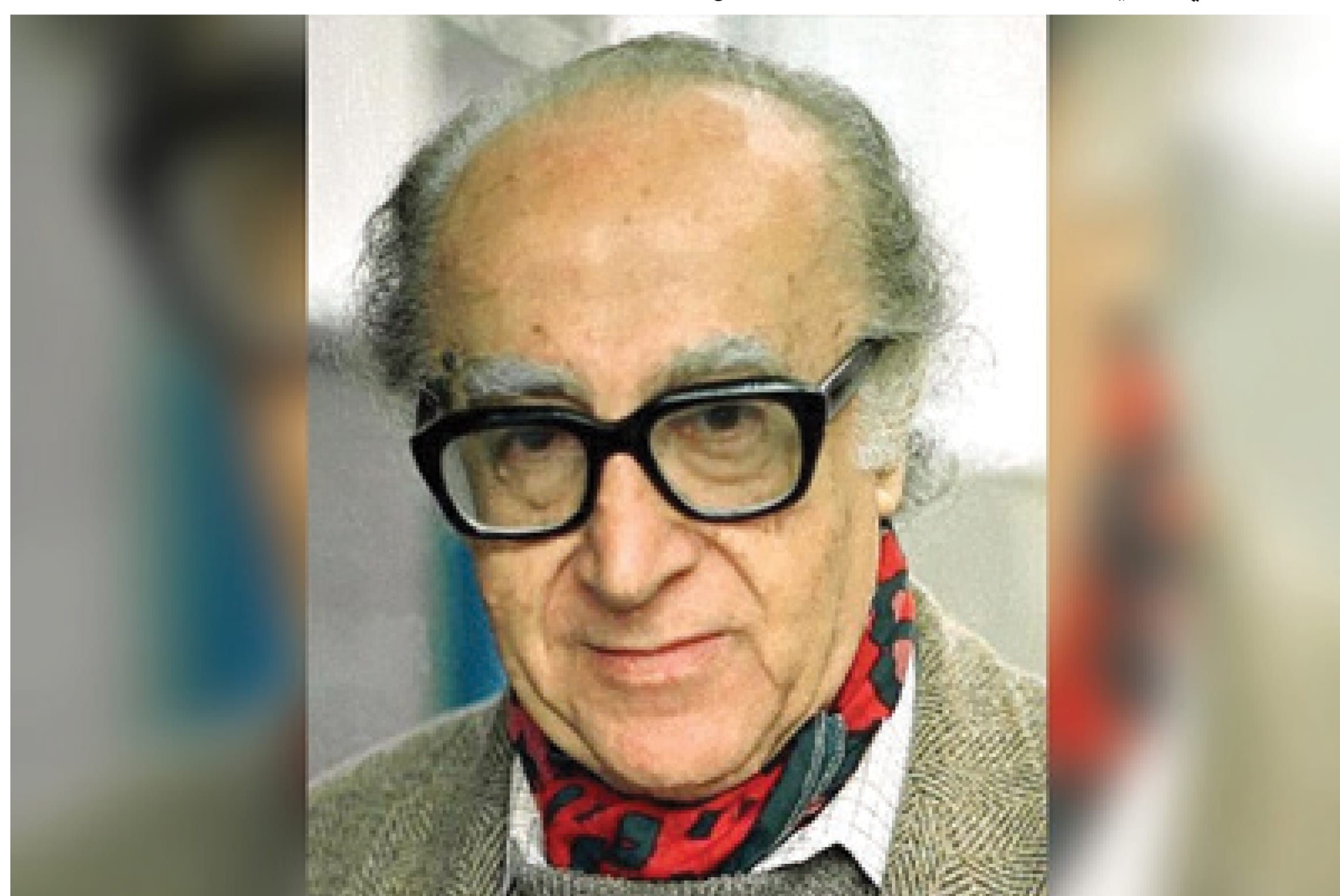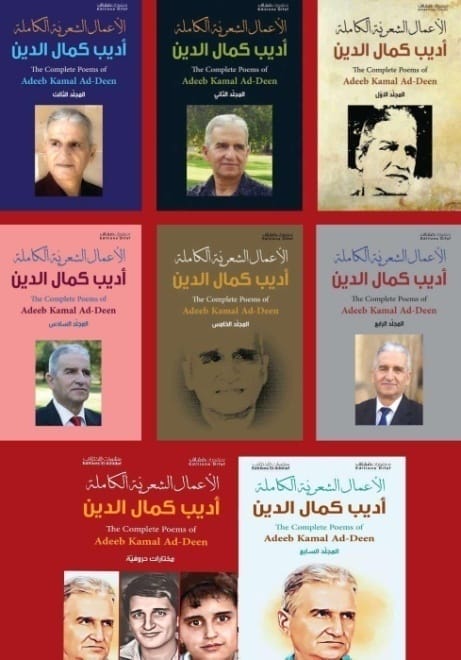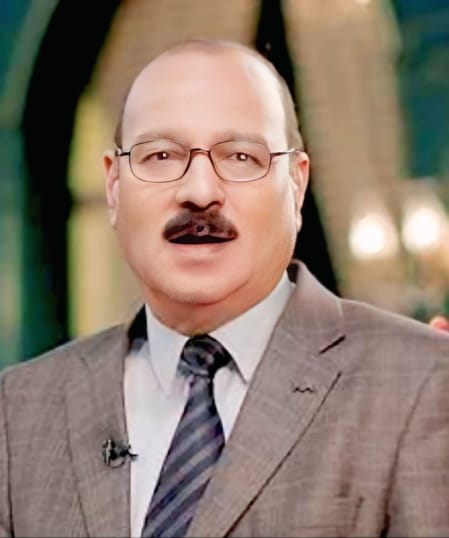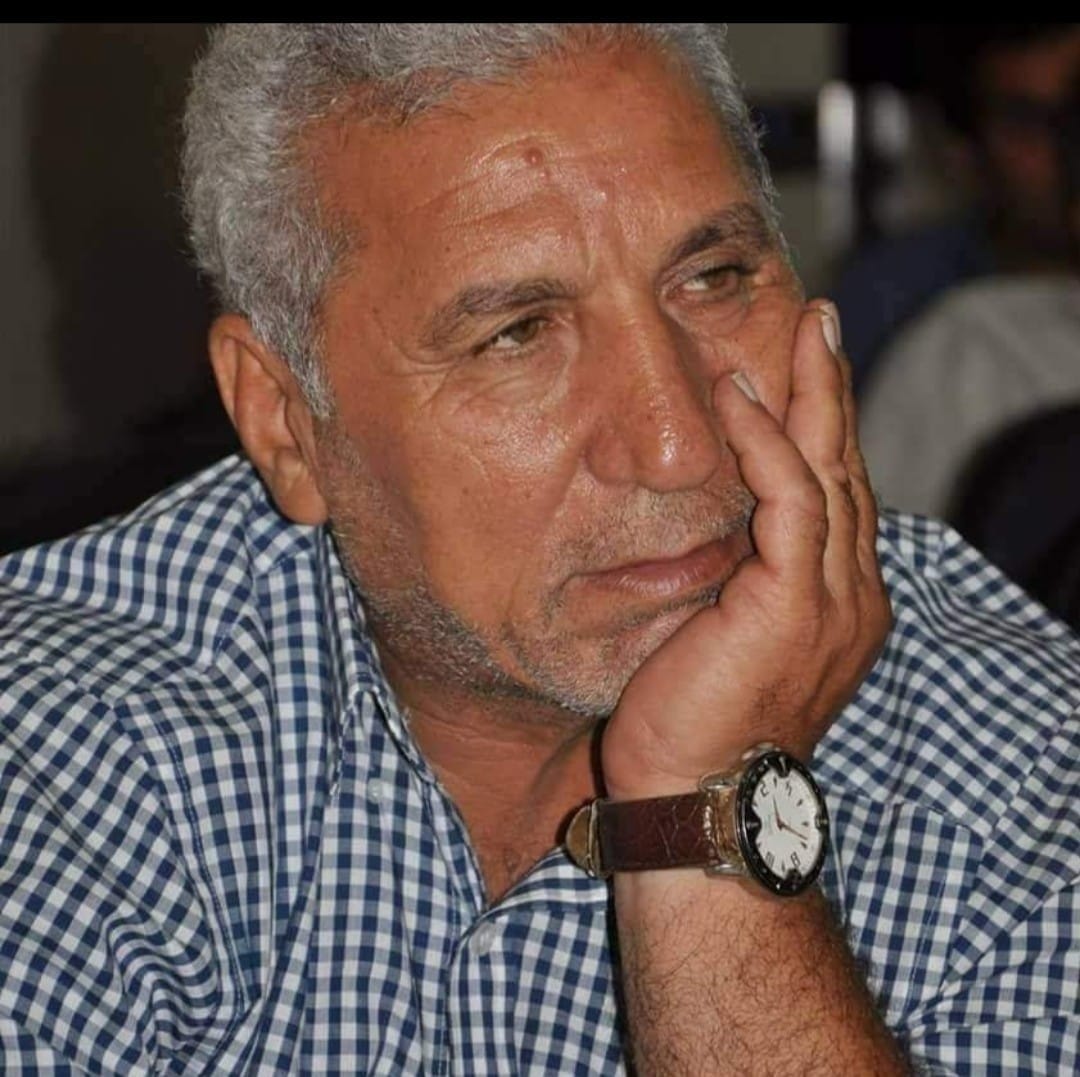يجتهد هذا الشاعر الاشكالوي (عماد المطاريحي) في تدشين كتابته عبر مستويات عديدة تدلل كلها على سعة معرفته الكتابية، وأية كتابة تلك، إنها الكتابة الشعرية المحكية التي طالما تصوَّرها البعض انها أسهل من الكتابة التي تسمى _ جوراً _ الرسمية، الفصحى لتُشعر ضمناً أن غيرها هامشي وغير رسميٍّ ولا يجب أن يُهتمَّ به على الوجه الأكمل .. أقول تصوَّرها البعض أسهل بسبب عدم حاجة كاتبها لقواعد نحوية أو صرفية فضلاً عن أن أمر الوزن الشعري في هذه الكتابة هو أمر فطري .. وبالطبع إنني أرى الأمر غير ذلك، على الرغم من أن ما سبق يصدق على آليات الكتابة المحكية، أي أنها لا تحتاج إلى النحو والصرف ووزنها فطري بطبيعة تعلُّمهِ، ولكني أرى أن كتابة المحكي أكثر قلقاً من كتابة غير المحكي (الفصيح) ذلك لأن جمهور المحكي أوسع من غيره، وعليه فإن عملية الإمتاع تكون حرجة ذلك لأن الكاتب يكون إزاء تحدٍّ مستمرٍّ وهو: كيف يمكن أن يُمْتِع المتلقي بلغةٍ هو يتكلَّمها دائماً؟!، كذلك كيف يمكن أن يحافظ على استمراره ممتعاً وسط هذا الحشد المتزايد يومياً من الشعراء؟!. إذن لابد له من أن يكون مميزاً بأدوات كتابته من جهة، وأن يتابع ويتعرَّف على ما هو حديث من جهة أخرى، وأن يطلع على الكتابات الأخرى كالرواية والمسرح والقصة و.. الخ من جهة ثالثة، لأن كل ذلك يزوِّده بمعارف جديدة ويطوِّر أدواته. بل عليه أن يطلع على اللغة المرئية التي تتمثَّل بالسينما والمسرح وإرساليات الإشهار وما إلى ذلك ليظل مواكباً لوقته ومستشرفاً للمقبل، و(عماد) شاعر اطلع على كثير من ذلك، لذا نجد نصَّه يستثمر مستويات عديدة في تشكُّله ولا يقف عند حدود الموهبة .. وفي ديوانه (المأذنه والبحر الأخضر) نجد تمثيلاً ناجحاً لذلك .. وهنا نعرض لبعض هذه المستويات.
د. حمد محمود الدوخي
1. المستوى الأول : عتبة العنونة :
فمنذ عنوان الديوان نلاحظ أن الشاعر يقصد الإنفلات من سطوة المألوف في الشعر المحكي، وربما عدم تنوينه لتاء (المأذنة) جاء قصديَّاً لتكون علامة أولية على أن المحتوى / محكيَّاً وليس (رسميَّاً) / فصيحاً .. هذا بالنسبة للعنوان العام للديوان الذي هو عنوان لإحدى القصائد ولكن بتصرُّفٍ قليل، فعنوان القصيدة (المأذنه والبحر الأبيض) وحوَّله إلى الأبيض ليعطي خصوصية لعنوان الديوان، فضلاً عن الدلالة التي يؤدِّيها الأخضر باعتباره لون الخصب والانفتاح، أما العناوين الداخلية/الفرعية، فمن الواضح عليها ومن خلال تأمِّلها في الفهرست قبل ربطها بمتنها الشعري، أنها مبنية بشاغول شاعر يمتلك حرَفيَّة باختياراته العنوانية، فبعض هذه العناوين يتواصل مع اللغة الأدبية الفصحى مثل (تراجيديا وطن/ذنوب النهار/وطن بلون الناس/نافذة .. الخ) وبعضها الآخر يتواصل مع لهجته المحكية مثل (بوسة عيد/مسخرة/مراسيم الضوه/سالوفة برد .. الخ) وهذا التنوُّع في التواصل إنما يدل على إحاطة حساسة يقصدها الشاعر من جهة، ومن جهة أخرى يدل على سعة اطلاع الشاعر. ومن القصائد التي نربطها بمتنها – أنموذجاً على حرفيَّة عماد – قصيدة (استفتاءات شعرية) إذ نلاحظ على هذه القصيدة أنها تُهيكل شكلها الكتابي على شكل مقاطع شعرية وكأنها أسئلة استفتائية وذلك تواصلاً مع العنوان، أي ان العنوان عكس ظلاله على أرض القصيدة، كذلك كانت لغة هذه المقاطع لغةً استفتائية إذ انطوت على صورٍ إيضاحية وأخرى جوابية جاءت إجابة على سؤال الاستفتاء، ومن الصور الإيضاحية قولهُ:
الصَّايم
عن دمِّ الناس
أفضل من صايم رمضان
ومتطوِّع ..
صايم عن جدَّه؟
ويفطر بآخر يوم بخبزة غيره
أما صورة الإجابة الشعرية على سؤال الاستفتاء الشعري الذي قام به عماد، فذلك في قوله:
ما حكم اليزرع؟
اليزرع طبعاً ينفع
واليزرع رمان؟
أكتب لا تزرع رمان
لازم يزعل حرف الراء إعله الرمان
حتى يصير بـ(بيتي)أمان
وهنا لابد من الإشارة إلى ان الصورة التي أرادها (عماد) هي صورة تأويلية وليست تشكيلية ذلك لأن حذف حرف (الراء) من لفظة (الرمان) لا يشكل لفظة أمان، إنما المفهوم من هذا الحذف في هذا السياق هو الأمان، كما هو التأويل لكلمة (بيتي) التي قوَّسها ليعطيها مخصوصية ويجعلها تحيل إلى الوطن.
2. المستوى الثاني، عتبة الإهداء :
يحمل ديوان (عماد) نوعي الإهداء، أي الإهداء العام (إهداء الديوان) والإهداء الخاص (إهداء القصيدة)، ففي إهدائه العام جاء متواصلاً مع انفتاح العنوان بخُضرته على الآخر، إذ يقول في إهدائه هذا (إلى الإنسان في جنوب الأرض أم في شمالها أسود كان أم أبيض، مادام وطنه المحبة ودينه الإنسانية) وهنا واضح حجم الانفتاح وخصوبة الروح المطاريحية التي لا تشترط في الإنسان إلا إنسانيَّتَهُ .. أما الإهداء الخاص فنجده متجسِّداً في قصيدة (بوسة عيد) فبه يقول (إلى(إ) نافورة العطر الأسمر ..) والملاحظ على هذا الإهداء أنه خضع لتكييف شعري (نافورة عطر+ تشخيص شعري لهذا العطر:أسمر) كل هذا التكييف علامة على منزلة المخصوص من الإهداء، فإذا أمكن أن تكون هناك نافورة عطر، فلا يمكن أن يكون عطرها أسمر، لأن توصيف أسمر لا يتصل مع حال العطر، ذلك لأن العطر يخضع لتشخيص حاسة الشم التي هي غير حاسة تشخيص اللون (أسمر) وهي حاسة النظر .. وبعد هذا الإهداء المكثَّف نجد (عماد) يناجي المُهدى إليه مناجاة مكثَّفة بـ(نافورة) من الكلمات، إذ يُوكلُ إليه أمره بالكامل .. وذلك بقوله :
انت وحدك تسكن بروحي قصيدة
انت وحدك ممكن تسويني شاعر
وممكن تسويني _ آنه _
وممكن تسويني _ غير _
ممكن تسويني دمعه
وممكن تسويني شمعه
وممكن تسويني طير
3. المستوى الثالث : مستوى الصورة :_
إن الصورة الشعرية عند (عماد المطاريحي) مشتغلة على مستوىً عالٍ من التقنية الكتابية التي يمتلكها، إذ نجده يكتب الصورة الشعرية بتراكيب تعتمد هندسة محكَّمة تترابط جزئياتها لتشكل صورة كلية تعطي مشهداً بانورامياً يحتوي ما يريد قوله الشاعر، ففي قصيدة (العش والحطاب) نجد هذا المشهد، إذ يعبِّر (عماد) بهذه الصورة المشهدية عن سخطه واعتراضه بقوله :
العش مو حطب خل يفهم الحـطاب العش بيت شرعي وساكناته طيور
وأحـياناً يضم عشاكَ متصافيــن أحلام وأريكة ونافذة إعله النـور
اعله غفلة من الزمن لن بيتهن مهدوم والغصن اليشيله من الأصل مبتور
الدستور، منقـوص اعله هذا الحال الحقيقة، العشكَ لازم ينكتب دستور
العصافير اعتراض إلهن عله الحطاب جـاب عشوشهن وانطاها للتنـور
هكذا نرى صورة (عماد) مرسومة بإتقان شاعر له أدواته الخاصة وفرشاته التي لا تضع حركة إلا ولها خصوصيتها وحضورها في اللوح الشعري، فالصورة هنا بانورامية لأنها تنطوي على موضوعية متكاملة (بداية وعقدة، أي تصاعد درامي، ونهاية).
4. المستوى الرابع : مستوى الأسلوب :
يحتكم (عماد) على أسلوب متنوِّع وثريٍّ في بناء نصِّه، فهو فضلاً عن الأسلوب المألوف لكتابة القصيدة المحكية يمتلك أساليب جديدة كل الجدة على أجواء القصيدة المحكية مثل ما أصطلحُ عليه بـ (الأسلوب المُمسرح) حيث يُمسرح (المطاريحي) قصيدته هذه، فنراه في المدخل العام للقصيدة يُهيِّئ الأجواء المسرحية، إذ يحدد عنصري الزمان والمكان بقوله : الزمان (آخر وركَه من آذار /
تاسع وركَه من نيسان)
المكان (كل الوطن شبر .. شبر)
بعد ذلك يبدأ (عماد) بترسيم (عنصر الإضاءة) ثم يفتتح الفعل المسرحي الحركة الأولى على خشبة القصيدة، وبتعداد سريع لوحدات الديكور، إذ يقول:
_ يطفي النور
يبدي المشهد بأول دور
ديناصور!
التهم المسرح والجمهور
أكل الناقد والديكور
شرب النور
بعد ذلك تأتي الحركة الثانية على هذه الخشبة توضيحاً للحركة الأولى، وتأخذ هذه الحركة _ الثانية _ قيمتها من طبيعة الإيضاح الذي تقدِّمه، بقوله:
يضوي النور
يفز المسرح والجمهور
لا .. تمثال ..
يا حيَّال .. !!!
جان يمثِّل ديناصور
هكذا يقدِّم هذا الكائن الحريري نصَّه عبر شبكة من المستويات ليعلن عن هويته الإنسانية التي ترتفع وضوحاً في قوله:
اني كائن من حرير
ينذبح عصفور أموت
ينولد عصفور أطير
هكذا الكتابة لدى (عماد المطاريحي) الشاعر الذي وعى ما كُتب قبله، ووعى ما يجب عليه كتابته، لذا اتخذ من (هروبه المستمر _ كما يقول الشاعر حمزة الحلفي _ عن خارطة التقليد) طريقة إلى خصوصية قصيدة عماد المطاريحي.